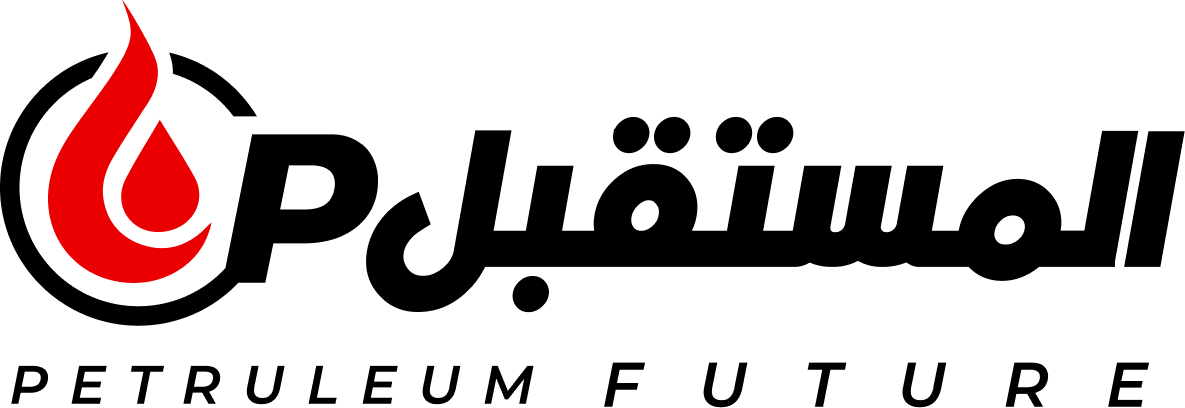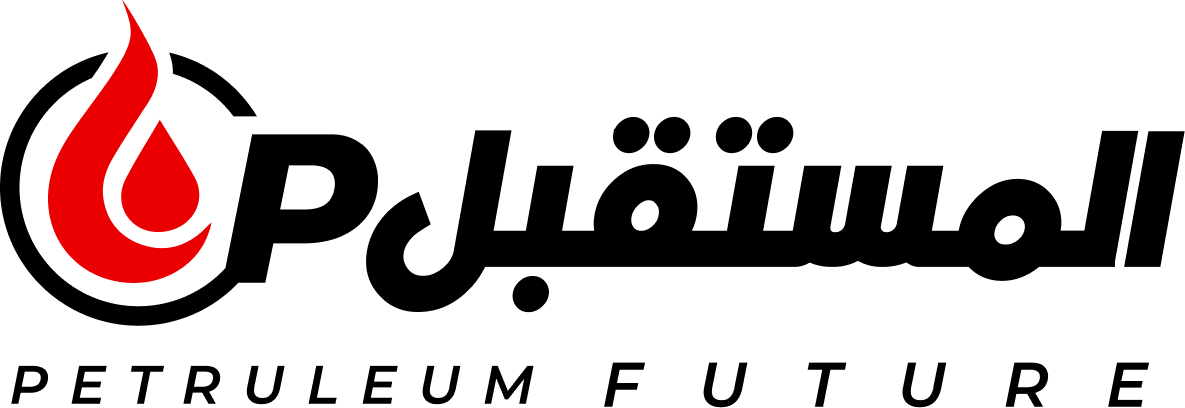وائل عطية يكتب: اتفاقية تصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر …قراءة من منظور المصلحة الوطنية

لم يَكُن الإعلان الإسرائيلي عن الموافقة على ما سُمي بـ أكبر صفقة غاز في تاريخ إسرائيل سوى مشهد جديد من مشاهد الخلط المتعمد بين السياسة والاقتصاد حيث يعلو الخطاب الدعائي لتتوارى الأرقام الحقيقية خلف الصخب السياسي.
فحين خرج بنيامين نتنياهو ليقدم اتفاق تصدير الغاز إلى مصر (بقيمة تقديرية تبلغ ٣٥ مليار دولار لتوريد نحو ١٣٠ مليار متر مكعب حتى عام ٢٠٤٠) باعتباره إنجازاً سيادياً، كان يتحدث بلغة السياسة الداخلية البحتة لا بلغة الأسواق ولا بمنطق صناعة الطاقة. أما القراءة الهادئة والفنية المجردة من الشعارات، فتقود إلى نتيجة واحدة لا تقبل التأويل: هذه الصفقة تؤكد مركزية مصر لا تفوق إسرائيل.
على عكس ما يوحي به الخطاب الرسمي فإسرائيل لا تمتلك ثروة من الغاز الطبيعي بلا حدود. فهي تعتمد فعلياً على حقلين بحريين رئيسيين هما ليڤياثان بطاقة إنتاجية تقارب ١,٢–١,٤ مليار قدم مكعب يومياً وحقل تمار المخصص تقريباً للسوق المحلي بطاقة ١ مليار قدم مكعب يومياً. هذا الإنتاج رغم أهميته يصطدم بواقع جغرافي واقتصادي صعب: سوق محلية صغيرة لا تستوعب الفائض وبنية تصديرية غير مكتملة وغياب تام لمحطات إسالة الغاز التي تمثل جواز المرور الحقيقي إلى الأسواق العالمية.
هنا تحديداً يبرز موقع مصر … لا كشريك تجاري فحسب، بل كبوابة حتمية. فالغاز الإسرائيلي مهما تعاظمت كمياته يظل بلا قيمة استراتيجية عالمية ما لم يمر عبر الأراضي المصرية ليُسال في محطات الإسالة في إدكو ودمياط ثم يعاد تصديره باسمها وعبر بنيتها الأساسية وعقودها الدولية إلى أوروبا وآسيا. مصر هنا ليست مجرد مشترٍ، بل هي المركز الإقليمي الذي لا بديل عنه.
حتى رقم الـ ٣٥ مليار دولار يحتاج إلى تحليل محاسبي، فالجزء الأكبر من هذه القيمة لا يدخل الخزانة الإسرائيلية، بل يصب في حسابات الشركات الأجنبية القائمة بالعمليات وفي مقدمتها شيفرون الأمريكية التي تتحكم في مقدرات التشغيل والاستثمار وتستحوذ على ما يقارب ٥٠–٦٠% من عوائد البيع. هذا يفسر التصريحات الصادرة من القاهرة التي تشير إلى أن المستفيد المالي الأول هي شركة شيفرون في حين تكتفي الدولة الإسرائيلية بالضرائب والرسوم.
في المقابل تخرج مصر بعائد صافٍ يُقدر بنحو ١١ مليار دولار (مباشر وغير مباشر) نتيجة رسوم الإسالة والتشغيل وإعادة التصدير وكل ذلك دون ضخ استثمارات رأسمالية جديدة تذكر مع تعزيز مكانتها كلاعب لا يمكن تجاوزه في معادلة الطاقة بشرق المتوسط.
في خضم هذا الجدل يتردد السؤال المعتاد والمغلف بالاتهام: لماذا تستورد مصر الغاز؟ وللإجابة يجب النظر إلى تحولات العقدين الماضيين … فمصر انتقلت من التصدير (٢٠٠٥-٢٠١١) إلى العجز والاستيراد عقب أحداث ٢٠١١ ثم عادت للاكتفاء الذاتي مع اكتشاف حقل ظهر (٢٠١٨-٢٠٢١). واليوم بفعل التراجع الطبيعي في إنتاج بعض الحقول وتنامي الطلب المحلي لتوليد الكهرباء والصناعة عادت مصر للاستيراد جزئياً.
هذا الاستيراد ليس علامة ضعف، بل هو أداة موازنة ذكية في سوق غير مستقر. فمصر تدير منظومة معقدة وتملك القدرة على تعويض أي عجز والذي يتراوح بين ٢ - ٣ مليار قدم مكعب يومياً حسب الموسم وذلك عبر استيراد الغاز المسال وتغييزه من خلال سفن التغويز المستأجرة بطاقة ضخ تفوق الاحتياجات الفعلية.
الغاز الإسرائيلي المستورد والذي يبلغ حده الأقصى مليار قدم مكعب يومياً تقريباً بحسب تصريحات المهندس كريم بدوي وزير البترول لا يمثل شريان حياة بقدر ما هو خيار اقتصادي بدليل أن توقف الضخ سابقاً كما حدث بداية حرب غزة لم يسقط منظومة الطاقة المصرية.
المفارقة الكبرى تكمن في أن الطرف المصري الذي يملك البدائل يتعامل بهدوء بينما إسرائيل المحاصرة بالخيارات هي من ترفع صوتها سياسياً. لو قررت مصر وقف الاستيراد ستتحمل تكلفة أعلى لكن منظومتها لن تنهار أما لو أغلقت مصر محطات الإسالة فإن الغاز الإسرائيلي سيتحول إلى ثروة غائبة تحت سطح البحر بلا مشتري.
من هنا فإن تسييس الصفقة هي صناعة إسرائيلية بحتة لتسويق الاتفاق داخلياً. أما مصر فتتعامل بمنطق الدولة الحكيمة التي تفصل بين الموقف السياسي والقرار الاقتصادي دون المساس بسيادتها.
إن صفقات الطاقة لا تُحسم بالخطب الرنانة، بل بالإمكانيات. ومن يملك الإمكانيات الكاملة ممثلة في خطوط الأنابيب ومحطات الإسالة ومنافذ التصدير لا يحتاج إلى الصياح لإثبات تفوقه.
هذه الصفقة ليست شهادة هيمنة لإسرائيل، بل هي إقرار عملي بأن مصر هي محور الارتكاز الذي يدور حوله غاز شرق المتوسط ومن يملك هذا الموقع يدرك جيداً أن القيمة الحقيقية للغاز تمر من خلاله ولا تتجاوزه.