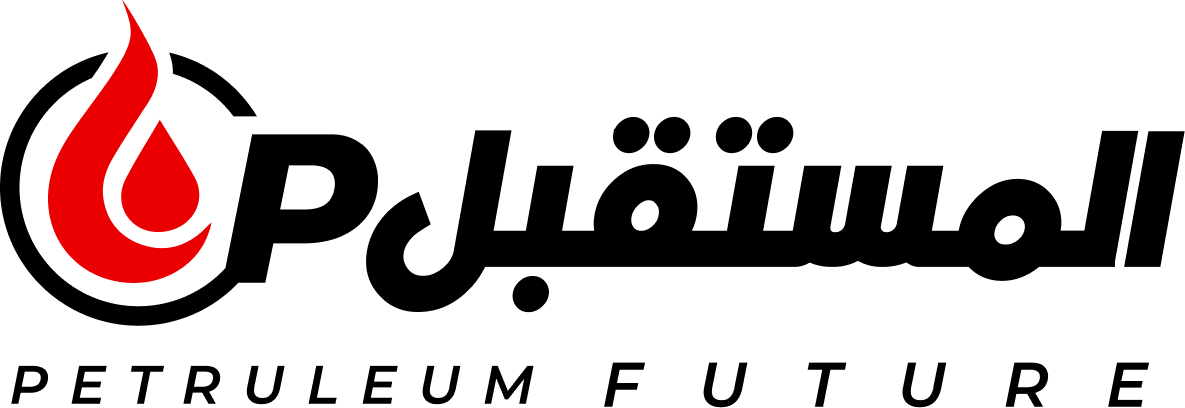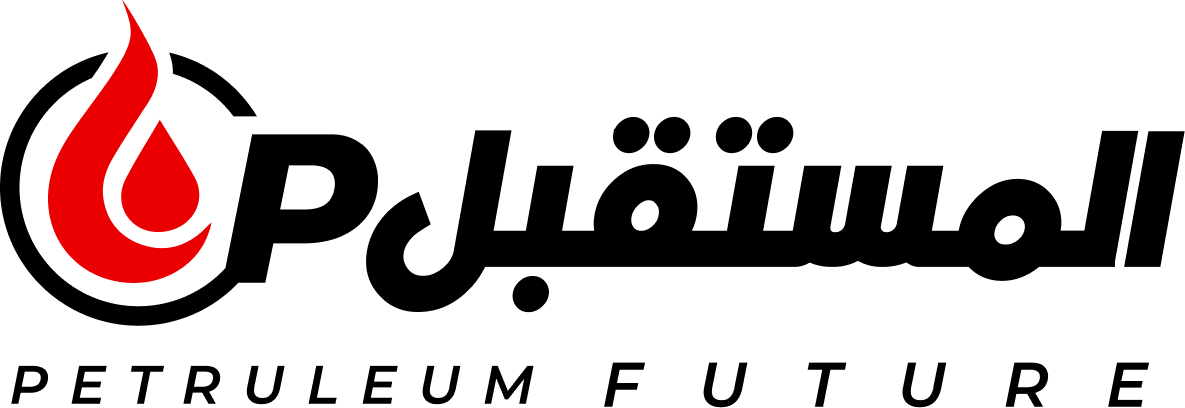أحمد البري يكتب: التعويم على طريقة الكابتن إبراهيم..حكايات من الماضي عن الحاضر

الجزء الأول:-
التسعينيات – يمكن وصف تلك الفترة بأنها واحدة من الفترات المفصلية في التاريخ المعاصر؛ شُيّع خلالها جثمان الاتحاد السوفيتي ملفوفًا بعلم الشيوعية وشعاراتها البراقة، وصار الغرب بنظامه الرأسمالي قبلة العالم الاقتصادية. غزا صدام حسين الكويت، وتشتّت المجتمع العربي ما بين مؤيد ومعارض، لكن الغنائم كلها ذهبت إلى أمريكا. هبط على البشر فيض من التكنولوجيا يكافح إنسان اليوم للحاق به، ربط العالم بشبكة معلومات “الإنترنت”، ومع الوقت صار هذا الرباط عند البعض أكثر أهمية من صلة الدم.
وبالنسبة لي – وكنت وقتها على أعتاب المراهقة – أذكر تلك الفترة بأنها كانت بداية نهاية أنفاس ومتنفس الساحات الشعبية ونوادي أبناء محدودي الدخل، تلك الأماكن التي خرج منها العديد من الأبطال في رياضات شتى. وخلف هؤلاء الرياضيين مدرّبون مجتهدون أغلبهم عاش ومات ولم يعرف في حياته مذاق الشهرة أو المال. ومن هؤلاء أذكر الكابتن إبراهيم مدرب السباحة بأحد تلك النوادي.
لم يكن سباحًا بارعًا، ولم يخض في حياته أي مسابقة في السباحة، لكن – وتلك إحدى مفارقاته – استطاع بإمكانياته المحدودة أن يخرج من بين يديه أبطال جمهورية، منهم من خاض منافسات دولية، ومنهم من صار يعيش على مهنة التدريب. وللكابتن إبراهيم شخصية وصفات تستحق أن تُروى.
كان شخصًا قد يبدو غريب الأطوار لدى البعض؛ يرتدي دومًا ملابس وفقًا لموضة السبعينيات: بناطيل ضيقة عند الوسط تزداد اتساعًا ناحية القدمين، قمصان مشجّرة ومخططة ضيقة تُبرز كرشه المنتفخ بصورة واضحة. يطيل شعره الكثيف ويطلق العنان لسوالفه، وله بنية ضخمة تشبه إلى حد كبير بنية الممثل الراحل محمود عبد العزيز. يأتي إلى التمرين راكبًا دراجته النارية ضئيلة الحجم “سوزوكي عصفورة”، والتي كانت منتشرة وقتها. ومع ضخامة جسده ودراجته الضئيلة، يخيل لمن يراه وهو يقودها أنه يرى رجلًا بالغًا يقود دراجة أطفال بثلاث عجلات خلفية.
قليل الكلام، يشير بيده لما يريد قوله أغلب الوقت. منضبط تمامًا في مواعيده، ومواعيد التدريب لديه مقدسة؛ لا يسمح لأحد أن يدخل بعده، ويمنع تمامًا المزاح أو تبادل الأحاديث بين المتدربين أثناء التمرين. كما يمنع أيضًا تواجد أي شخص خارج الماء أثناء فترة التدريب. يجلس على مقعده ممسكًا السيجارة في يده اليسرى وكوب الشاي في يده اليمنى، ويراقب المتدربين عن كثب. وإن قام عن مقعده، فهذا يعني أن هناك ملاحظة هامة يجب الانتباه إليها.
كان يفرك إصبعيه الأوسط والإبهام بصوت مسموع طلبًا للتركيز، ثم يبدأ في تقليد أداء حركي معين، ويرفع إصبعه السبابة في الهواء محركًا إياه مثل بندول الساعة إشارة إلى خطأ الأداء، يتبعها توضيح الأداء السليم لحركة الذراع أو القدمين أو الرأس. لم يكن الكابتن إبراهيم يؤمن بأن هناك أداءً وسطًا في السباحة؛ فهي إما سباحة أو “عوم ترع” على حد وصفه.
وفي المرات القليلة التي تحدث فيها مثل باقي البشر، وصف لنا السباحة بأنها رياضة هندسية ميكانيكية، تخضع لقواعد صارمة في زاوية وحركة كل عضو من أعضاء الجسم. وكان يرى أن لفظ “سبّاح” لا يجب أن يُطلق على من يجيد السباحة فقط، بل السباح هو من يستطيع سباق المنافسين الذين يجيدون السباحة. وكان أيضًا يعتقد أن السباحة أحد العلوم الحركية وليست مجرد “بلبطة” في الماء، لذا لم يترك أي مصدر معلومات سواء مرئي أو مقروء إلا واطّلع عليه.
خصص الكابتن إبراهيم ساعة واحدة يوم الخميس قبل التمرين لاختبار وانتقاء المتدربين الجدد الراغبين في الانضمام لمدرسة السباحة. وكان يشترط ألا يكون قد سبق لهم التدريب من قبل، وأن ينتظرهم ذووهم في حديقة النادي أثناء فترة الاختبار. وقتها كنت أنا وبعض أصدقائي ضمن المتدربين بالمدرسة، وكنا ننتظر ذلك اليوم بفارغ الصبر، نظرًا لطرافة وغرابة أسلوب الكابتن إبراهيم في اختيار المنضمين الجدد.
يُجرى الاختبار في الجزء العميق من حمام السباحة “عمق 6 أمتار تقريبًا”، ونجلس نحن المتدربين على سور الطرف الآخر لمشاهدة “الزملاء المحتملين”. ويتم إخلاء حوض السباحة باستثناء اثنين من المنقذين يكونان متواجدَين داخل منطقة المياه التي يُجرى بها الاختبار، إلى جانب اثنين آخرين من قدامى المتدربين أقوياء البنية يكونان إلى جوار الكابتن.
يدخل الراغبون في الانضمام إلى المدرسة فرادى حتى باحة حوض السباحة – معظمهم من الأطفال أو في سن المراهقة – تاركين ذويهم بالخارج. تبدو على أغلبهم علامات التوتر والقلق، واصطكاك الأسنان، واهتزاز الفرائص. يستقبلهم الكابتن إبراهيم بلا مبالاة، الواحد تلو الآخر. يقف الكابتن مولّيًا وجهه ناحية حوض السباحة، وفي مواجهته يقف الراغب في التمرين وظهره للماء. يمد الكابتن إبراهيم يده لمصافحته ويسأله عن اسمه، وقبل أن يجيب المسكين يباغته الاثنان الأشداء المرافقان للكابتن بحمله من تحت الإبط ثم إلقائه إلى منتصف المياه العميقة.
وهنا تبدأ ردود الأفعال المتوقعة وغير المتوقعة التي كنا نشاهدها ذلك اليوم؛ فمنهم من يدخل في نوبة من الصراخ أو الضحك، ومنهم ما هو أطرف ويطول ذكره. ومن المواقف التي لا تُنسى في ذلك “اليوم المفتوح” عندما حضر إلى حمام السباحة شخص مهم في أوائل الأربعينيات من العمر، ذو طلة مهيبة، وشارب كثيف، وجسد ممشوق لا تخطئ العين رؤية عضلاته البارزة. كان يُدعى “أيمن بك”.
استقبله الكابتن إبراهيم استقبالا رسميًا غير معتاد، واتخذت ملامح وجهه علامات الخشوع والرهبة في آن واحد. ثم طلب الكابتن منه على استحياء أن يتفضل بالقفز إلى الماء العميق للبدء في تمرين تنظيم عملية التنفس. وقف الرجل على حافة حمام السباحة، ثم اتخذ وضعية القفز شاخصًا بصره إلى السماء كمن يؤدي تحية العلم، وقفز بخفة إلى المياه.
لكن على غير المعتاد، لم نرَ تلك الفقاعات الهوائية الناتجة عن زفير الهواء من الرئتين. طال غيابه تحت الماء، وتحول وجه الكابتن إبراهيم إلى اللون الأحمر، تلاه الأصفر، ثم جثا بركبتيه على حافة الحمام، مائلًا برأسه على الماء حتى كاد يلامسه. أخذ يربت على سطح المياه بظهر يده وكأنه يطرق باب منزل مراعيًا عدم إزعاج قاطنيه، وهو يقول: “يا أيمن بك، معاليك سامعني؟” ثم يميل بأذنه إلى سطح الماء متخيلًا أنه سيأتيه الرد من أيمن بك القابع في قاع الماء العميق.
عاود الكابتن إبراهيم النقر على الماء قائلًا: “أيمن باشا… معاليك كويس؟” فهَمَس زميل ماكر جالس إلى جواري قائلاً: “كأن الانتقال من البكوية إلى الباشوية سوف يحدث فرقًا”.
عند تلك اللحظة أشار الكابتن إبراهيم بعصبية إلى جميع المنقذين بالقفز في الماء لانتشال أيمن بك. ولولا حياؤه لصاح بهم أن حاضره ومستقبله راقدان في الماء رفقة الباشا الذي لا يبدو له أثر.
غطس المنقذون سريعًا ثم صعدوا إلى سطح الماء حاملين أيمن بك، وكان جسده متصلبًا يكسوه اللون الأزرق، ولا يزال في الوضعية التي قفز بها. أمددوه على الأرض، وبدأوا في إجراء الإسعافات الأولية المعتادة في مثل حالته. أفاق أيمن بك بعد أن أخرج من فمه كمية كبيرة من الماء دفعة واحدة. وما إن استعاد وعيه حتى صرخ قائلًا: “وداني… أنا مش سامع حاجة!”
فكان رد فعل الكابتن إبراهيم أكثر غرابة من أفعاله السابقة؛ إذ رقد بجوار أيمن بك على سطح حمام السباحة متخذًا وضعية النوم على الجانب الأيمن، وحشر فمه داخل أذنه وأخذ يردد بصوت مسموع مع التكرار: “بسم الله… الله أكبر”، فيما يده اليسرى تدلك صدر أيمن بك بكل حنان ورهبة.
حكايات “تجارب الأداء” ما زالت قصصي المفضلة حين أجتمع مع رفقاء النادي. نتذكرها ونضحك عليها من باب التندر والتسلية. لكن تجربة أداء صديقنا “أكرم” – أو لنكن أكثر دقة: المكيدة التي دبرناها له – ما زالت هي القصة الأكثر عمقًا، والتجربة التي أثمرت عن نتائج لم نكن نتوقعها.
وهو ما سوف أرويه في الجزء الثاني…